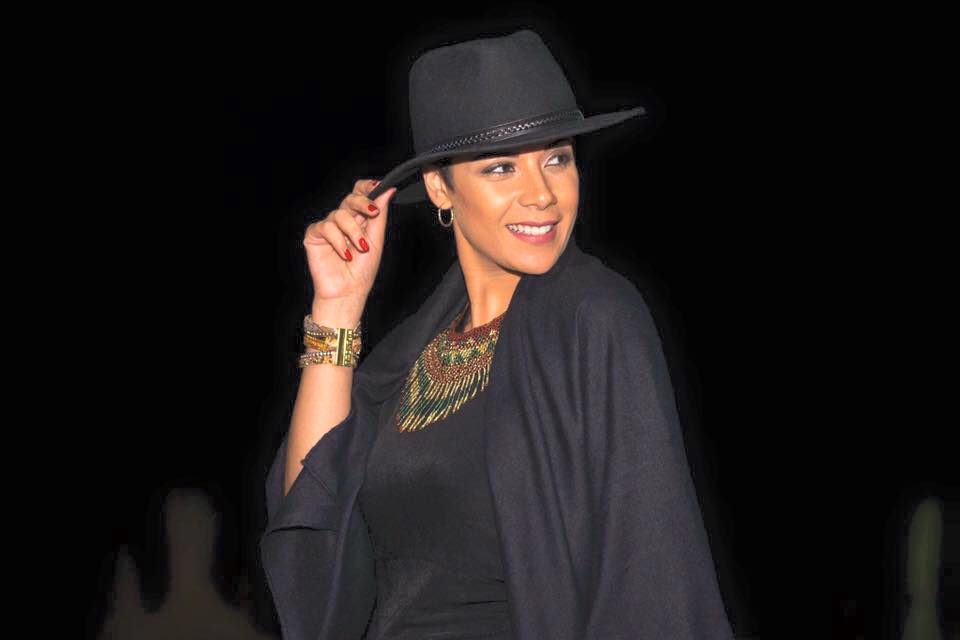خبراء: تحقيق الأمن الغذائي في المغرب مرهون بإصلاح جذري للسياسات الفلاحية

في ندوة نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية، اليوم السبت 12 أبريل الجاري، حول “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس” بالرباط، وجّه عدد من الخبراء والمختصين في الاقتصاد الزراعي والصيد البحري انتقادات حادة لما اعتبروه فشلاً استراتيجياً في تحقيق الأمن الغذائي بالمغرب، محملين مخططي "المغرب الأخضر" و"أليوتيس" مسؤولية تعميق التبعية الغذائية، واستنزاف الموارد المائية والبيئية، وتهميش الفلاحين الصغار، مقابل تمكين الفئات المهيمنة اقتصادياً من أدوات الإنتاج والدعم العمومي.
وأجمع عدد من الخبراء والمختصين في الاقتصاد الزراعي والصيد البحري بضرورة مراجعة السياسات الفلاحية والبحرية بشكل جذري، من خلال بناء منظومات إنتاجية تراعي الإمكانيات البيئية، وتعتمد على تقييم مستقل وشفاف، وتضع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في قلب كل مشروع اقتصادي، بعيداً عن منطق التصدير الأعمى والاستنزاف المتسارع للثروات الطبيعية.
وتحدث العربي الزكدوني، المهندس الخبير والمستشار في الاقتصاد الزراعي والتنمية القروية، بصراحة عن اختلالات بنيوية في مخطط المغرب الأخضر الذي تم إطلاقه عام 2008، قائلاً إن هذا البرنامج ركّز منذ بدايته على رفع الإنتاج الفلاحي دون مراعاة الوضعية المائية الحرجة للمغرب، وكأن البلاد في منأى عن مخاطر الاستنزاف والجفاف.
وأوضح أن هذا التوجه الإنتاجي المكثف تجاهل التوجيهات الملكية التي صدرت منذ التسعينات، والتي شددت على ضرورة استدامة التنمية الفلاحية، وعلى ضرورة عقلنة استعمال الموارد الطبيعية، خاصة الماء، في ظل التغيرات المناخية.
ومن الأمثلة الصارخة على هذا التناقض، أشار الزكدوني إلى زراعة تمر "المجهول" في منطقة بوذنيب، حيث تم تحويل أراضٍ رعوية تابعة للجماعات السلالية إلى أراضٍ فلاحية، بدعم مباشر من الدولة، رغم أنها غير مهيأة للزراعة، وهو ما تم من خلال حفر آبار عميقة واستغلال مكثف للمياه الجوفية.
كما انتقد الخبير ذاته التوسع في زراعة الأشجار المثمرة، خاصة الزيتون، حيث شجعت الدولة عبر برامج الدعم عدداً من الفلاحين على استغلال أراضٍ رعوية، وتحويلها إلى أراضٍ مشجرة تسقى بتقنيات الري الموضعي، ما أدى إلى تقليص الرقعة الرعوية بنسبة تجاوزت 70% من مليون ونصف هكتار تمّت زراعتها ما بين 1974 و1996.
وفي ما يخص زراعة الحوامض، أكد الزكدوني أن المساحة المزروعة ارتفعت من 80 ألف هكتار إلى 120 ألف هكتار بدعم مباشر من الدولة، غير أن توالي سنوات الجفاف منذ 2018، والتراجع الحاد في الموارد المائية، أدى إلى تراجع المساحة المزروعة مجدداً إلى 80 ألف هكتار، وكأن شيئاً لم يكن، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الاستثمارات العمومية ومدى التزامها بمبدأ الاستدامة.
أما في القطاع الحيواني، فكشف الزكدوني عن رقم صادم يتمثل في استيراد المغرب لحوالي 500 ألف بقرة حلوب منذ عام 1994 إلى حدود 2024، بمعدل 10 آلاف بقرة سنوياً، دون أن يتمكن من بناء منظومة وطنية للإنتاج الذاتي لهذا النوع الحيوي من الماشية.
وأوضح أن هذا الاستيراد الدائم يعكس غياب رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب، كما أن غالبية الأعلاف الحيوانية المستعملة في المغرب مستوردة، إلى درجة أن نحو 6 ملايين قنطار من القمح يتم تحويلها إلى أعلاف للحيوانات، بدلاً من توجيهها للاستهلاك البشري، ما يُبرز حجم الخلل في الأولويات.
وفي ما يخص القطيع الوطني، أكد الزكدوني أن أعداده شهدت ارتفاعاً منذ الثمانينات، خاصة الأغنام، بفعل برامج إنقاذ القطيع، إلا أن هذا الارتفاع تم على حساب الموارد الرعوية التي لم تعرف أي توسع مقابل نمو القطيع، بل إن هذه الموارد تقلصت بشكل لافت.
وأوضح أن المساحات المزروعة ارتفعت بمليون ونصف هكتار خلال العقود الماضية، لكن 70% منها تم انتزاعها من الأراضي الرعوية، مما أدى إلى تدهور المنظومة البيئية الرعوية ورفع الضغط على الموارد المتاحة.
بدوره، قال عبد اللطيف سودو، رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، إن مخطط المغرب الأخضر فشل في تحقيق التوازن بين الفلاحة التصديرية والمعيشية، وأدى إلى تهميش الفلاحين الصغار، رغم أنهم يشكلون العمود الفقري للأمن الغذائي المحلي.
واعتبر أن الدعم العمومي وُجّه أساساً إلى كبار المستثمرين، في وقت لم يتحقق فيه الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، مثل الحبوب والسكر والزيوت، التي ما زالت تستورد بكميات كبيرة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتزايد مظاهر الهجرة القروية، وتقلص مناصب الشغل في المجال الفلاحي.
وسجل أن الأراضي المستعملة في زراعة المنتجات الموجهة للتصدير، مثل الأفوكادو والبطيخ الأحمر، تُستهلك كميات هائلة من المياه في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مائية غير مسبوقة.
أما على مستوى الصيد البحري، فقد كشف سودو أنه رغم الطموح الذي رفعه مخطط "أليوتيس" لتحقيق تموقع عالمي قوي، فإن الإنتاج الفعلي في تربية الأحياء المائية لم يتجاوز 400 طن سنوياً، مقابل الهدف المعلن في المخطط والمحدد في 200 ألف طن، في حين أن 39% من المشاريع نُفّذت جزئياً، و25% لم تُنفذ بعد، وتم إنجاز 25 مشروعاً فقط من أصل 70 مشروعاً مبرمجاً.
من جانبه أكد محمد الناجي، الأستاذ الجامعي والخبير في الصيد البحري، أن السياسات الفلاحية والبحرية في المغرب تنهل من نفس المرجعية النيوليبرالية التي تضع السوق والتصدير فوق مصلحة المواطن والبيئة.
وقال إن المغرب رغم تحقيقه اكتفاء ذاتياً في بعض المنتجات، مثل الدجاج والطماطم، إلا أنه يفتقر للسيادة الغذائية، بسبب تبعيته للخارج في المدخلات الزراعية، بما فيها البذور الأساسية.
كما أشار إلى أن النزيف المتسارع للثروة السمكية، نتيجة الصيد الجائر وسوء المراقبة، يهدد استدامة القطاع على المدى الطويل، خاصة في ظل غياب مقاربات تشاركية فعالة، وتردي الموانئ، وتراجع جودة البيئة البحرية بسبب الأنشطة البشرية والتغير المناخي.